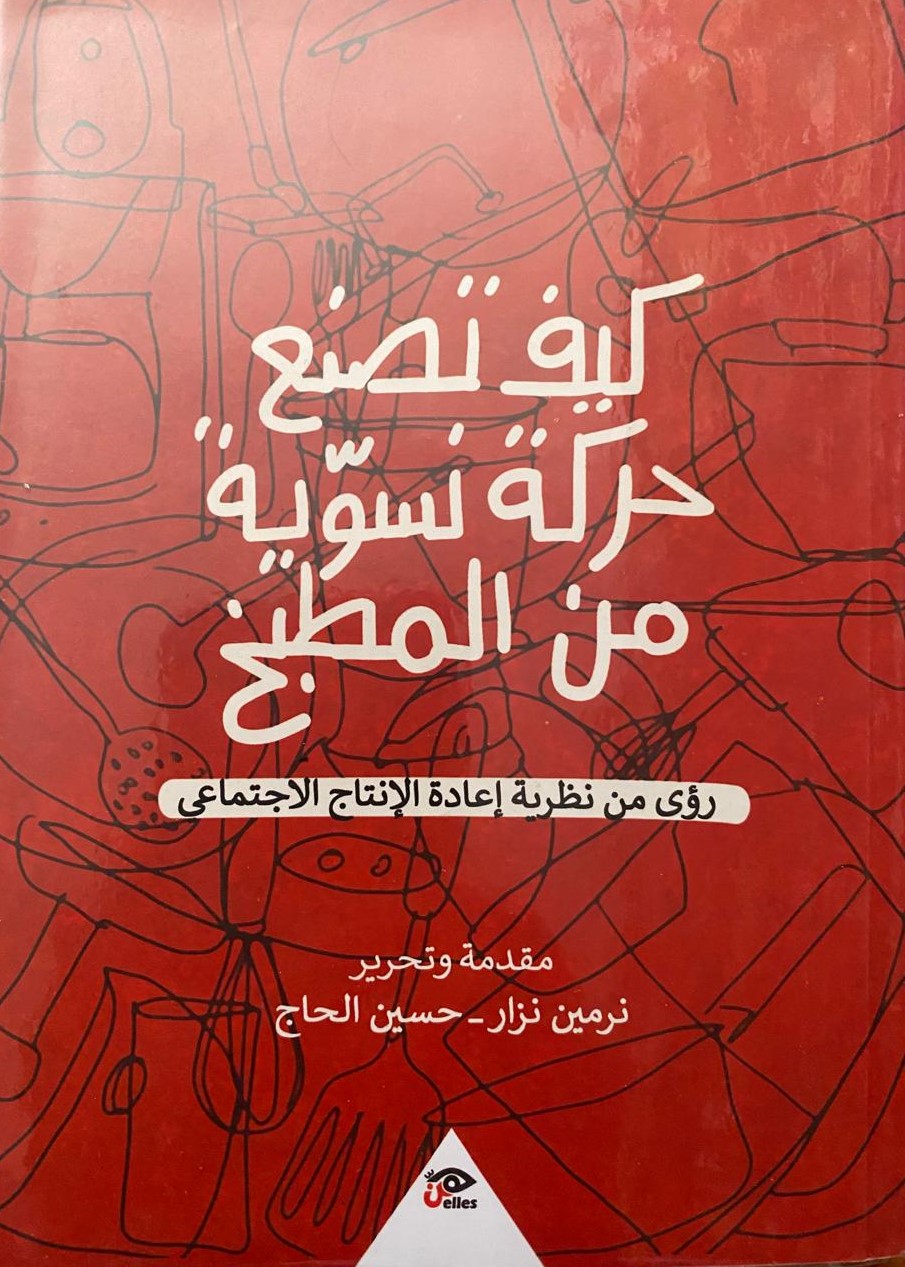مقدمة من طبخت العشاء الأخير(تاريخ العالم كما ترويه النساء)
بقلم: روزاليندا مايلز
سيرا على قاعدة “التاريخ يرويه المنتصرون”، جرى ضمن اضطهاد النساء تسييد كتابة تاريخ العالم بمنظار الذكور. وضمن الكفاح النسوي جهودٌ متكاثرة لتصويب الميزان المختل. إنها جبهة نضال نسوي تحظى باهتمام متنام على صعيد أممي، يتعين ان ننهض محليا بواجب إبراز المطموس من دور النساء في صنع تاريخ المغرب. واجب يستدعي إطلاعا على المنجز النسوي متعدد التجارب. منه كتاب “من طبخت العشاء الأخير(تاريخ العالم كما ترويه النساء).
تعريفا بالكتاب، وحفزا لقراءته، وشكرا لكاتبته وناشره العربي ننشر مقدمته.
جريدة المناضل-ة
المقدمة
من طبخ العشاء الأخير ؟!
إن كان رجلاً، ألن يُخصص له يوم بين أعياد القديسين، ويصبح شفيعاً للطهاة المشهورين ؟! أسئلة كهذا السؤال أوقعتني في المشاكل منذ أيامي الأولى في المدرسة، حين بدا لي آنذاك أنّ التاريخ – مثل كل شيء آخر في العالم – هو تاريخ الذكور كل مخططات فجر التاريخ في المدرسة الابتدائية، تصور الرجل البدائي وهو يخطو بثقة إلى المستقبل، لكن دون أي أنثى ترافقه ! الرجل – الصياد ضمن انتقالنا إلى أكل اللحوم وبالتالي زيادة حجم أدمغتنا، الرجل – صانع الأدوات نحت رؤوساً للرماح، الرجل – الرسام اخترع الفن في الكهوف… إلخ. على ما يبدو، تسلّق «الرجل شجرة التطور وحيداً نيابة عنا جميعاً، ولم يخطر لأحد أن المرأة لعبت دوراً في ذلك، أياً كان!
تتابعت العصور، وبالكاد ظهرت بعض النساء في المشهد في مواكب التاريخ المبهرجة، المؤلفة من الحروب والبابوات والملوك، شاركت النساء فقط عند فشل الرجال. جان دارك قادت الفرنسيين بسبب عدم وجود رجال يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة، والملكة إليزابيث الأولى حكمت إنجلترا بسبب عدم وجود وريث ذكر للعرش، بينما كانت البطلات اللاحقات كفلورنس نايتنغيل وسوزان بي. أنطوني معزولات نوعاً ما عن عالم الرجال، وعزلتهن هي شرط مسبق لتحقيق الشهرة. استشهاد جان دارك وعذرية إليزابيث، وعنوستهما الذكورية المتقشفة، كلها لم تستهو خيال البنت الصغيرة التي كنتها آنذاك.
النساء اللواتى حفظت كتب التاريخ أسماء من نادرات … أين الأخريات؟ إنه سؤال ملح رفض أن يفارقني، ولذلك كتبتُ من طبخت العشاء الأخير ؟ في محاولة للإجابة عليه، على الأقل بالنسبة لى نقطة انطلاقي كانت سؤال غيبون – مؤرّخ الإمبراطورية الرومانية الشهير – الذى لا يقبل المساومة: ما هو التاريخ ؟ إنّه أقرب إلى سجل عن جرائم الرجال، وأخطائهم، ومصائبهم . أغرانى التحدّي، وأخيراً! أعلنتُ بشجاعة اليد التي تهز المهد، أمسكت بالقلم كي تصحح السجلات: هناك نساء فى التاريخ أيضاً !» . بتلك الكلمات الشجاعة، صدرت النسخة الأولى من هذا الكتاب بثقة أكبر مما شعرت به في الحقيقة، لأنني لم أعرف كيف سيستقبله القراء، لكن كما اتضح لي، لم أكن الوحيدة التي يؤرقها غياب النساء عن كتب التاريخ. احتفاء الجمهور بكتابي، فاق أحلامي ! منذ صدور الطبعة الأولى تحت عنوان «تاريخ العالم كما ترويه النساء»، طبع هذا الكتاب مراراً وتكراراً، وتمت ترجمته إلى ما ينوف على الثلاثين لغة بما فيها اللغة الصينية مؤخراً، وألهم سلسلة تلفزيونية وعرضاً منفرداً قدمته امرأة، فضلاً عن الاقتباسات العديدة منه بلغات مختلفة، التي تغص بها شبكة الإنترنت.
على مستوى الأفراد، ردود الفعل تجاه تاريخ النساء» كانت مذهلة أيضاً! لقد لامس كتابي العقول والقلوب، في جميع أنحاء العالم. في أوروبا وأمريكا، زارتني النساء كي يشكر نني على كتابته، ثم انفجر بالبكاء، كما كتبت إلى العديدات شخصياً، وتضمنت رسائلهن اعترافاً بسيطاً: «لقد غير الكتاب حياتي !». كتبت لي جدة في الثمانينيات من عمرها، كي تقول إنها اشترت نسخاً لبناتها وحفيداتها جميعهن، لأنّ الوقت فات بالنسبة لها، لكن ليس بالنسبة لهن في بلجيكا، أخبرتني طبيبة نفسية أن إحدى مريضاتها جاءت وهي تحتضن نسخة من كتابي فتحته على الإهداء إلى كل نساء العالم اللواتي لم يكن لهنّ تاريخ، وأعلنت بغضب : «إنها أنا ! هذه قصتي !). أعز ذكرى على الإطلاق، زيارة شابة من جامعة ساوث ويسترن يونيفرسيتي في جورج تاون تكساس، أهدتني قرطين من الكريستال وقلادة جميلة ورثتها عن أمها الراحلة، مرفقة برسالة ما زلت أحتفظ بها حتى الآن، قالت فيها: «بعد قراءة هذا الكتاب، أصبحت قادرة للمرة الأولى على موضعة تجربة حياتي الشخصية ضمن تاريخ النساء الأعم. إنه ما أصبو إليه في الحياة الآن، ولم أكن سعيدة هكذا من قبل. من فضلك البسي القلادة والقرطين وتذكري كل النساء اللواتي أثرت على حياتهن في تكساس.
أردت أن أجيبها بأنّ الفضل لا يعود لي، بل للنساء اللواتي ألقيت الضوء على قصصهن الناشر الأول لهذا الكتاب وأبوه الحقيقي، روجر هيوتون وصفه بـ «أعظم قصة لم ترو من قبل !». في الحقيقة، كانت النساء فاعلات وكفوءات ومهمات خلال جميع عصور الإنسانية، ومن المفجع ألا نعي جميعنا ذلك . الشجاعة والطاقة والحيوية الهائلة التي تكشف عنها شخصيات الكتاب، كانت مصدر إلهام يومي بالنسبة لي وأنا أتصارع مع كتالوج تاريخي لا نهائي، عن قمع المرأة واستغلالها من وجهة نظري، الاحتفاء بـ «النساء المشاكسات حول العالم ليس كافياً، أي تاريخ حقيقي للنساء يجب أن يأخذ بحسبانه كل ما جرى معهنّ، وأن يفحص من خلالهن ما جرى مع الرجال، والأطفال، وفي العالم كله.
هذا الإصدار الثاني تحت عنوان جديد، وبنسخته المنقحة والمعدلة، هو الإصدار الأول الذي يظهر كاملاً في الولايات المتحدة الأمريكية. الطبعات السابقة هذبت اللغة وأزالت الطرائف، باعتبار أنّ الموضوع جدي للغاية، وليس من اللائق أخذه بهزل برأيي الموضوع جدي للغاية لذلك يجدر بنا التعامل معه بطرافة، لأنّ التاريخ لا يصدق حول الحياة إن لم يقدم استراحة كوميدية … أنا سعيدة لرؤية النص هنا كما كتبته ! إعادة إصدار الكتاب بصياغته الأصلية أدفأت قلبي، لأنها دليل على أنّ الاهتمام بالموضوع لم يخمد قط، بل على العكس، تنامى اهتمام الناس حول العالم أكثر فأكثر بقارة أتلانتس المفقودة تلك التي تمثل تاريخ النساء، وقصّة الكثير من الحيوات الضائعة.
تاريخ النساء، لماذا؟
مع ذلك، سيسأل البعض: لماذا تكتبين عن تاريخ النساء بالمطلق؟ ألم يتقاسم الرجال والنساء العالم دوماً ، واختبروا معاً حسناته وسيئاته ؟! يسود الاعتقاد بأن الجنسين كليهما عانيا الظروف نفسها على حدّ سواء، لكن كان من حق الفلاح الذكر مثلاً – مهما عانى من القمع الغاشم أن يضرب زوجته، وتوجب على العبد الأسود أن يكدح من أجل سيده نهاراً ، لكنه لم يضطر لخدمته ليلاً كالمرأة السوداء. هذا النموذج القاتم ما يزال مستمراً إلى يومنا هذا، إذ تتحمّل النساء حصة إضافية من الألم والتعاسة مهما كانت الظروف، كما تشهد معاناة المرأة في أوروبا الشرقية التي مزّقتها الحروب الذكور قاتلوا وماتوا، لكن الاغتصاب الجماعي الممنهج، المترافق غالباً مع التعذيب ذاته الذي يتلقاه الرجل وينتهي بالموت، كان مصيراً عانت منه النساء فقط ! تاريخ النساء ينبثق من إدراكنا لتلك اللحظات، رغم أن الوعي بوجود الفروقات ما يزال وليداً. لم يبدأ المؤرخون بدراسة التجربة التاريخية لكل من الرجال والنساء بشكل منفصل، إلا في عصرنا الحالي فقط، وعندها أدركوا أن مصلحة النساء تضاربت مع مصالح الرجال خلال الجزء الأكبر من ذلك التاريخ، وأن الرجال عارضوا اهتمامات النساء، ولم يمنحوهنّ تلقائياً الحقوق والحريات التي حصلوا هم عليها. بالتالي، أصبح التقدم خاصاً بالرجل فقط. عندما يركز التاريخ حصرياً على نصف الجنس البشري فقط لا غير، تضيع الحقائق والحلول البديلة. الرجال يهيمنون على التاريخ لأنهم من يكتبونه، وما كتبوه عن النساء الناشطات الشجاعات الذكيات أو العدوانيات يميل دائماً إلى التعامل معهن بطريقة عاطفية، أو تحويلهن إلى أسطورة، أو إلى جرّهن مجدّداً إلى نوع من الوضع الطبيعي) المتعارف عليه. لذلك، معظم ما يُسمّى بـ «السجلات التاريخية خاطئ ببساطة. مثلاً، لم تُرمَ جان دارك إلى المحرقة بسبب الهرطقة، بل لارتدائها ملابس الرجال، وهو مصير عانت منه الكثيرات حتى القرن الثامن عشر. فلورس نايتنغيل لم تُلقَّب قط بـ سيّدة المصباح» بل بـ «سيدة المطرقة»، وهي صورة حرّفها مراسل صحيفة التايمز الحربي ببراعة، لأنها كانت ثقيلة على الناس في الوطن. لم تكسب نايتنغيل لقبها من التجول في المستشفى حاملة مصباحها، بل من هجومها العنيف على باب مستودع مغلق، عندما رفض الأمر العسكري إعطاءها اللوازم الطبية التي تحتاجها.
نحتاج تاريخ النساء»، لأن هناك جهوداً لا تنقطع تنكر مشاركة المرأة، وتهدف إلى تأكيد التفوّق الطبيعي» للرجل، مهما كلف الأمر. من يعرف اليوم أن مالك الطاولة المستديرة لم يكن الملك آرثر، بل غوينيفر ؟! أو أن أجيالاً من الملكات المتحاربات في الهند والسعودية، ساهمن بصنع الصورة الحالية لبلادهن ؟! التحريف لم يقتصر فقط على الماضي السحيق الضبابي، من يعرف اليوم كتائب القتال التخصصية التي قوامها النساء فقط، والتي قاتلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية؟ من يعرف ما هو الدور الذي لعبته المرأة في اكتشاف الكوازار أو DNA؟ ماذا عن برنامج رحلات الفضاء المخصص للنساء في وكالة ناسا، خلال الحقبة الذهبية للهبوط على القمر ؟ لقد كان برنامجاً ريادياً أغلقته ناسا فجأة دون تقديم مبررات، رغم أن أداء النساء كان – على الأقل – بمستوى أداء الرجال ذاته !
التذكير بموقع النساء المركزي بالنسبة للجنس البشري مهم للغاية، كي نحارب الاعتقاد الراسخ بأنّ التمييز ضد النساء هو أمر مقبول في كانون الأول من عام 2000، احتفت مجلة التايم بغاندي وونستون تشرشل باعتبارهما رجلين من بين ثلاثة حملوا لقب شخصية القرن»، نظراً لما يتمتعان به من حكمة ومهارة في القيادة، واحترام الناس جميعهم لهما. الوثائق الموجودة عن حياة الرجلين العظيمين»، تكشف دون مواربة عن أن غاندي كان يغتصب النساء، وأن تشرشل كان عدواً شرساً للنسوية طيلة حياته. مع ذلك، لم تتلاشَ عَظَمَتُهما! لو استبدلنا «النساء» بـ «السوداوات»، و «عدو النسوية» بـ «المتعصب عرقياً»، سيتضح لنا أنهما يستحقان الخزي والعار، لا الانتخاب في بانثيون العظماء
مع بزوغ فجر الألفية الجديدة، شهدت نهاية القرن العشرين اندفاعاً لإعادة تقييم التاريخ، بدءاً من المقالات في المجلات وحتى مجلدات التاريخ الضخمة، لكنّ المرأة لم تحظ في أي منها بأكثر من إيماءة عابرة. على ما يبدو، ما زال على تاريخ النساء» أن يخوض معركته !
من وجهة نظري، يجب على تاريخ النساء» أن يشرح الوقائع لا أن يسردها فحسب، كي يكشف أسبابها الكامنة، ويملأ الفراغات العديدة ما بينها، وأن يقدّم تفسيراً مُرضياً للسؤال الذي حيّرنا، كما لم يفعل أى سؤال آخر على مر الزمن : كيف أصبحت المرأة خاضعة ؟! يجادل البعض أن الاختلاف بين الجنسين متجذر فى الطبيعة، وأننا ننتمي إلى جندرين مختلفين نقطة انتهى ! بينما يعتبر آخرون أن الاختلاف بين الذكر والأنثى، ناجم عن البيولوجيا الاجتماعية sociobiology، ويمثل أوّل مظاهر التقسيم الاجتماعي الذي قام به الجنس البشري، قبل ظهور القبائل وقبل الأعراق…. إلخ. طيلة قرون عديدة، سلّم كل من الرجال والنساء بالأمر الواقع: الجنسان يعيشان في «فضاءين منفصلين، وهو قَدَر بيولوجي تفرضه الطبيعة، ويفرضه الرب. هذا الفصل الجندري، بإصراره قانونياً ودينياً واجتماعياً وثقافياً على دور المرأة الثانوي، كرّس دونية النساء حتى عندما قدس الأنوثة وبجل الأمهات، ليباركهن الرب !
ألقت الطبيعة الأم العبء الأكبر في عملية الإنجاب على عاتق المرأة، كما يجادل البعض، لذلك يجب على المرأة أن تخضع لهيمنة الرجل ابتغاء للحماية، سواء لها ولأطفالها بمراجعة السجلات التاريخية، سنكتشف أن المرأة في المجتمعات البدائية»، تمتعت بدرجة أعلى من المساواة مع الرجل قياساً للحضارات الأكثر تقدماً، وإن نظرنا إلى النساء باعتبارهن موجودات في مركز التاريخ، لربما استطعنا أن نفهم لماذا تمتعت المرأة بحرية أكبر فيما مضى، وهو تناقض أساسي يميز عصرنا. امرأة ما قبل التاريخ مارست الصيد وركضت حيثما تشاء، وتجولت حيثما تريد ومارست الجنس مع شريك اختارته بملء إرادتها، كما صنعت الفخار والأدوات، ورسمت على جدران الكهوف، وزرعت ونسجت، ورقصت وغنت. قيامها بجمع الطعام كان أمراً لا غنى عنه لبقاء القبيلة، ولم يتحكم بها أو يحد من نشاطاتها أي ذكر على النقيض من ذلك، تغلغلت الهيمنة الذكورية في كل مناحي الحياة في المجتمعات «المتقدمة»، وواظبت على ابتداع ترسانة من الأسباب الدينية والبيولوجية والعلمية» والسيكولوجية والاقتصادية، لتبرير دونية المرأة بالنسبة للرجل. يسخر المؤرخون من تنامي شهرة وسطوة الداروينية الجديدة، التي سلبت خيال الناس مع نهاية القرن العشرين، لأنها وظفت الجينات لتبرير كل شيء، ابتداء من الوسواس القهري الجنسي وصولاً إلى العدوانية الذكورية، بينما ظلت خرافة «الدافع الجنسي الضعيف عند المرأة مقبولة دون التحقق منها لو كانت صحيحة لماذا تحتاج المجتمعات إذن إلى تشكيلة ضخمة من الروادع والعقوبات لإبقاء جنسانية البنات والزوجات تحت السيطرة ؟!) في الحقيقة، الادعاء الساذج بأن الرجل مُبَرمَج لنشر بذرته بينما لا ترغب المرأة إلا بذكر يحميها، والادعاء العتيق بتفوّق الذكر، هما وجهان لمقولة واحدة. الدفاع التقليدي عن فكرة تفوّق الذكور أثبت مقاومته للزمن، أما المرأة التي يُنظر إليها باعتبارها مبرمجة بيولوجياً على الدونية، فما زالت محرومة من حقها الإنساني المتمثل بالإرادة الحرة المستقلة بشكل تام.
لماذا الآن؟
أين نحن الآن، بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على انطلاق أقوى فعالية متمحورة حول المرأة شهدها العالم يوماً ؟ اعتباراً من حقبة الستينيات في القرن العشرين تلاقت النساء وانطلقن ووسعن آفاقهن إلى مستوى جديد، وسبرن أغوارهن الحراك الذي خاضته المرأة آنذاك على الصعيدين الاجتماعي والشخصي، شبيه بنضالها الطويل المرير للحصول على حق التصويت. مع ذلك، لم تنحصر تطلعاتها بهدف واحد فقط، بل أرادت تغيير العالم كحد أدنى، ويجدر بالذكر أنها قطعت شوطاً هائلاً باتجاه ذلك، فحققت في تلك الحقبة القصيرة المدهشة الصاعقة، انتصارات فاقت كل ما سبقها عبر آلاف السنين ظفرت المرأة مؤخراً بالحق بالتعليم، وبالحريات المدنية وممارسة المهن المختلفة، وحق الانتساب للجيش والحكومة والكنيسة. من ناحية أخرى، حملت الثورة الاجتماعية معها قوّة اقتصادية وفرصاً متكافئة وحق التصويت والسوتيان، والحق بالإجهاض، وفوط التامبون، وجوارب النايلون امرأة القرن العشرين تسلّقت جبل إيفرست، دارت في الفضاء، وقطعت شوطاً مذهلاً. قادت الطائرة القتالية، وأصبحت قاضية في المحكمة العليا، وصناعية بارزة، كما أدارت البلدان والشركات، وتعاملت مع ميزانيات تُقدَّر بمليارات الدولارات بالثقة ذاتها التي ربت بها أطفالها في الأزمنة الغابرة. هذا الاندفاع نحو التقدم فتح أبواب حقبة من التغيرات الهائلة بالنسبة للرجال والنساء وكل من حولهم على النقيض من التقدم الذي أحرزته المرأة سابقاً، والذي كان أقرب إلى إنجازات على الصعيد الشخصي. نجاح أول طبيبة مثلاً أسهم بنجاح جنس النساء ككل، لكن ببطء.
نشأنا في حقبة شهدت تضامناً لا مثيل له سابقاً بين النساء، ومنه انبثقت انتصارات شهيرة، كما أن إزالة بعض العقبات القديمة الظالمة الواضحة أسهمت بتركيز طاقة المجتمع على ما تبقى منها. ها نحن أولاء أخيراً نشهد محاولة مستمرة لاجتثاث آلاف السنوات من التحيز ضد المرأة، وقيام الحكومات والأفراد بتمويل الحملات، وتسخير الوقت والإرادة السياسية الحقيقية في دعم عملية التغيير. هذا بدوره وضع عالمنا الجديد الشجاع أمام تناقضات مدوّخة، وأسئلة مثيرة للاهتمام في الأعوام المئة المنصرمة، خطت المرأة خطوات عملاقة نحو الاستقلالية الفردية وتحقيق الإنجازات أكثر مما فعلت خلال آلاف السنين، لكن بماذا سنصف العصر بالمجمل إن كانت اثنتان من الأيقونات النسوية الخالدة فيه، جاكلين أوناسيس كينيدي وديانا أميرة ويلز، مشهورتين فقط بسبب أزواجهما، لا بسبب مواهبهما الشخصية؟! ديانا، وهي أكثر امرأة احتفى بها العالم على الإطلاق، أصبحت مشهورة من خلال تجسيدها لفانتازيا سندريلا بزواجها من الأمير، من ثم حصدت الإعجاب بإظهار هشاشتها». بشكل عام، لماذا لا يزال من العسير على النساء الملوّنات أن يحصلن على فرص متكافئة مع غيرهن من النساء، ناهيكم عن تحقيق التكافؤ مع الذكر الأبيض المهيمن؟! وماذا عن سيدات صناعة الجنس، اللواتي ينشطن بصناعة منتجاتٍ تُدان بشدة عندما يسوقها الرجال؟ أو السيّدات الملاكمات اللواتي يقاتلن للدخول إلى رياضة، بعدها الكثيرون متوحشة ومهينة، حتى بالنسبة إلى الملاكمين الذكور؟ على الأقل، تتمتع الملاكمات في الغرب بحرية الاختيار، لكن بالنسبة لمعظم نساء العالم، الحرية هي مجرد فردوس خيالي، وحدها الأفاعي حقيقية فيه. أن تكوني امرأة في الصين أو الهند أو إفريقيا أو الشرق الأوسط، يعني أن تتعاملي يومياً مع رجال يؤمنون إيماناً راسخاً بأنّ النساء مخلوقات أدنى مرتبة، خاضعات لسيطرتهم وفقاً لمشيئة الإله»! كل منظومات الإيمان الكبرى في العالم اليهودية المسيحية الإسلام، البوذية، الكونفوشيوسية – تصر على دونية المرأة كجزء من العقيدة. صحيح أن بعض النساء شققن طريقهن بالالتفاف على هذه النقطة طيلة آلاف السنين، وأن العديد من المجتمعات اليوم تنأى بنفسها عن كل تلك الأفكار الصريحة التي لا تقبل النقض، لكن مع تجدد التطرف، يبرز التعصب العتيق مجدّداً إلى السطح، ويحاول أن يهدم ما بني.
الظروف الحديثة لا تعني التقدم بالضرورة، والعديد منها يكرر الأخطاء السابقة، فضلاً عن ظهور أنماط جديدة من القمع هي – كسابقاتها – مجرد أعراض لعدم تكافؤ جوهري من الصعب تبين جذوره، ناهيكم عن اجتثاثه تماماً. تاريخ النساء يجب أن يرفع صوته ضد همجية الماضي، التي تولد اليوم متنكرة بهيئة جديدة. لا يمكننا تلافي التناقض الأساسي المتمثل بأن الحياة تتحسن بالنسبة للبعض، بينما تتخذ مساراً أسوأ بالنسبة للبعض الآخر في الوقت ذاته. التقدم المادي والتكنولوجي غير المسبوق خلق فساداً لا يمكن تخيله، واستغلالاً سادياً للقوة تلعب المرأة فيه كما هو الحال دائماً – دور الطرف المتلقي. فكروا بالمثال المرعب التالي: سياسة تحديد النسل في الهند والصين تسببت بموجات جديدة مخيفة من قتل الإناث سواء الرضيعات أو الأجنّة). قبل خمسة عشر عاماً، كنتُ أخرج مع العديد من النساء في مظاهرات للاحتجاج على تطبيق اختبار بزل السائل الأمنيوسي، الذي يُرَوَّج له باعتباره طريقة تسهم بزيادة نسبة المواليد الأصحاء، بينما يُستَغَلّ على نطاق واسع في الواقع بهدف إجهاض الأجنة المؤنثة غير المرغوب بها، ففي عام 1984 / 1985 فحسب تم إجهاض 16000 جنين أنثى في عيادة واحدة في بومباي مع بزوغ الألفية الجديدة الأنظمة الباترياركية المتعصبة ما زالت تطالب بالصبية علانية وبوقاحة وتفضل الذكور على الإناث، وما زالت فاعلة تتنامى دون روادع في بقية أرجاء الشرق، تكافح المرأة اليوم للحصول على حقها بالتعليم والاستقلالية الفردية، بينما تسبغ المحاكم الذكورية شرعية على ما تُسمى «جرائم الشرف»، باعتبارها مقبولة فى القانون كحق أزلى من حقوق الزوج بقتل زوجته الخائنة
(أو لمجرّد شبهة الخيانة)، وقتل المراهقة العزباء الحامل. توسّع هذا الحق مؤخراً فى الباكستان وبعض الدول العربية، ليطال قتل أخت أو أمّ أو زوجة أب تلطخ سمعة العائلة. بتر الأعضاء التناسلية ما يزال قدراً يترصد الملايين من الفتيات الإفريقيات. فى الكويت لم تحصل النساء على حق الاقتراع .بعد (1). في السعودية، تتعرض المرأة التي تشدّ عن الطريق المرسوم لها إلى التعذيب والعنف والموت. فى أفغانستان، شنّت منظمة طالبان الشنيعة حرياً شرسة على الجنس الأنثوى بأسره، وطردت النساء من وظائفهنّ وقامت بتعذيبهن وقتلهن لمجرد الاشتباه بأنهن خرقن القوانين الدينية، وهي قوانين أشد قسوة من تلك التي فرضها النازيون على اليهود أثناء الهولوكوست، ولا تعد المرأة – مثل اليهود في الماضي – «شخصاً» في ظلها. في معظم أرجاء العالم غير الغربي، ترسخ القوانين الحديثة فكرة عمرها قرابة ألفي عام، وهي أن شهادة رجل واحد في المحكمة تعادل شهادة أربع نساء أو أكثر. حتى ولو تمتعت المرأة في القرن العشرين بالحرية كي تصبح جيانغ كينغ أو إنديرا غاندي، ستبقى عرضة للسقوط المدوّي وللعقاب الذي واجهته هاتان المرأتان: الحبس الانفرادي مدى الحياة بالنسبة للأولى، ورصاصة في البطن بالنسبة للثانية. أحد الدروس التي نستخلصها هنا، هو ضرورة أن نتخلص إلى الأبد من فكرة أن تأنيث السياسة ستقودنا إلى عالم أفضل، ومن فكرة أن القائدات الإناث ألطف من الرجال في الحقيقة، القوة العاطفية تسير يداً بيد مع الحماقة الصارخة والجشع المخزي، من كان سيدين إيميلدا ماركوس مثلاً، قبل أن يسير ميلاً بحذاء من أحذيتها التي يبلغ عددها 2047 زوجاً ؟! زوجات الرجال الأقوياء – مثل إيميلدا السعيدة، وإيلينا تشاوشيسكو الجشعة، زوجة الدكتاتور الروماني الدموي الأخير – ينحدرن إلى مستوى منحط للغاية بسبب هو سهنّ بامتلاك الأشياء، حتى لو حللنا ذلك وفق معايير الحكومات التي تستغل شعوبها. في الوقت نفسه، تستطيع معظم النساء حول العالم الحصول على الكوكا كولا لكن ليس على الماء النظيف، وابتياع السجائر لكن ليس موانع الحمل، وابتياع أشرطة الفيديو الإباحية لكن ليس الدواء لأطفالهن !
مما سبق، يتضح لنا أن تاريخ النساء يجب أن يركز أكثر على امرأة تنتمي إلى عالم مختلف عن عالمنا نحن امرأة تُجبر على الزواج وإنجاب الأطفال قبل الأوان، وتقاسي العنف المستمر والموت المبكر، وبالتالي تبدو مشاكلنا ومصائبنا في العالم الغربي هامشية قياساً لما تعانيه. مع ذلك، كلما تطور مجتمعنا أكثر، وكلما امتد التواصل العالمي، واجهت النساء المزيد والمزيد من التضييق، فضلاً عن الهيمنة الذكورية التي تتنامى من حيث المدى والتعقيد، وهو أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار نحن اللواتي نعيش في مجتمعات الغرب المتقدمة». حتى في العالم الغربي الذي ينظر إلى نفسه بوصفه قائد الكوكب، تعيش النساء في مجتمع ما زال الرجل يهيمن فيه على مجالات القوانين والسياسة والعمل والصناعة والحكومة. حقوق النساء لم تصل بعد إلى مستوى يكافئ حقوق الإنسان»، أي الحقوق التي يدعيها الرجال ويطبقونها على أنفسهم. الأهم من هذا كله، سواء عبر وسائل الإعلام الجماهيرية أو من خلال ديكتاتورية الشركات التي تقرر ماذا نلبس وماذا نأكل وماذا نقرأ وبماذا نؤمن أو نفكر، ما يزال الحق الأساسي المطلق وهو حق التعريف ملكاً للرجال يتحكمون به كما يشاؤون.
رغم ذلك، لم تستسلم النساء مطلقاً لتلك المحاكمات، أو للأنظمة القائمة منذ آلاف السنين سواء الاجتماعية أو القانونية أو السياسية أو الدينية التي دأبت على اعتبارهنّ أدنى من الرجال. كل تقدم اكتسبته المرأة بشق الأنفس، ترافق مع عزم لا يكل سار بعكس التيار المرأة لم، ولن تكون أدنى مرتبة من الرجل، ولا تعتبر نفسها كذلك. بالتالي، كلما تفاقم القمع القديم الذي يتنكر عادة بصور جديدة غير متوقعة، ستنشب ثورة جديدة، وستكتشف النساء في كل جيل جديد مقدار قوتهن، وتضامنهنّ، وتاريخهن السياسي. هذا ليس سهلاً، حتى في العصور الحديثة في القرن الماضي، عندما تركزت جهود العالم على الحروب التي يصر الرجال حصراً على شنّها، حُرمَت المرأة مراراً وتكراراً من حرية التعبير ومن العمل المثمر وأجبرت على العودة إلى المنزل. بالتالي انفصلت كل امرأة عن الأخريات وعن النشاط الاجتماعي، ولهذا لم تنجح النساء بتأسيس، أو بترسيخ تقليد قوى مستمر مقبول في الحقلين الاجتماعي والسياسي على غرار تكتلات القوى الذكوريّة كنقابات العمال أو الأحزاب السياسية. لذا، في كل ثورة جديدة، كان على المرأة أن تكتشف الأشياء من جديد وأن تخترعها من الصفر، وصولاً إلى عصرنا الحالي.
نجحنا الآن أخيراً بقلب المعادلة ! صحيح أن هذه الحقبة طرحت علينا تحديات صعبة، لكنها قدمت لنا فى الوقت ذاته فرصاً لا تُعوّض، اغتنمتها النساء جميعهن، حتى أولئك اللواتي رفضن النسوية علناً! بعد ما ينوف على القرن من إعلان شارلوت بركنز جيلمان أن «المنزل ليس بحاجة إلى الزوجة أكثر من حاجته إلى الزوج، تحررت النساء – في الغرب على الأقل – من طغيان الكدح المنزلي، الذي يُعتبر واجباً من واجبات الزوجة، وقيداً تفرضه التقاليد على حياتها. ربة منزل بدوام كامل» أصبحت خياراً، ولم تعد أي امرأة مجبرة على لعب أدوار النساء الصغيرات والزوجات الصالحات بتعاسة وندم، أو على حساب الآخرين. الآن، بعد انتهاء نشوة الانتصارات القانونية والمدنية الأولى، وبعد ألق إنجازات السيدات الأوائل الشهيرات) أول امرأة تشارك في الماراثون، أول امرأة تقود طائرة بوينغ 747، أول امرأة تمنح جائزة نوبل… إلخ)، بدأت امرأة القرن الحادي والعشرين بالتحرر من نير تلك الحلقة القاتلة، التي يقوم فيها العدو باستجماع قواه في مكان آخر بعد كل انتصار من انتصارات النساء بإحساس صقلته الخيبات المتتالية أدركت النساء أن التكرار متأصل في نضالهنّ، وفهمن أن الظروف التي كسبن خلالها حقوقهن وحريتهن سابقاً بشق الأنفس، هي بحد ذاتها التي تقوض تلك الحريات والحقوق. لقد حققن تقدّماً في زمن التغيير الاجتماعي، حين بدأت كتل القوى الراسخة بالتصدع والانزياح، مما أفسح المجال لهن (ولكل المهمشين الآخرين) باختراق تراكيب كانت ممنوعة عليهن سابقاً. بالتالي، كان تقدم النساء لدخول الحياة الاجتماعية، أو عالم العمل الخاص بالرجال، مرتبطاً بأزمنة الاضطرابات والأزمات المرأة على الجبهات قاتلت وأطلقت الرصاص، والمرأة المهاجرة عملت في وظائف وترشحت لمناصب في المدن أو اتحاد التجارة. حقبة ما بعد الستينيات من النضال من أجل التحرر نجمت عن فترات الكساد العالمي المتتالية، ورفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في بعض البلدان بلغت %47% في بريطانيا)، تماماً كما حصل أثناء الحربين العالميتين، عندما هجرت ملايين النساء منفضة الغبار للعمل في المصانع، وأقسمن ألا يعدن مجدّداً إلى العمل في المنزل… لكنهن عُدْنَ بالطبع، فقد اكتسبت الخدمة المنزلية اسماً جديداً! مع نهاية الحرب العالمية الثانية، طردت أجيال بأكملها من المهندسات الصاعدات و روزي المُبَرشمة (2)) فجأة من سوق العمالة الماهرة، وعادت مجدداً إلى المنزل. لا يهم كم كان العمل ضرورة حياتية للنساء آنذاك، وكذلك قيادة السيارة أو توافر دور الحضانة ودور الرعاية النهارية للأطفال كي يتاح لهن وقت للقيام بأعمالهن، فقد عُدَّت كل مظاهر التحرّر تلك استجابة مؤقتة للأزمة وبالتالي تقوضت تماماً مع انتهائها . المناخ العام المتجسد بعدم اليقين وخيبة الأمل والخوف الذي حرضته الأزمة الكبرى، ترافق مع واقع امتلاك النساء للوظائف، وعدم تواجدهن في المنزل كـ حضور دافئ يرحب بالزوج، ما بين رائحة الكعك الطازج والنار في المدفأة. لا يهم أن هذه الصورة كانت غائبة طيلة عقود، وأنها قد تختفي إلى الأبد : تقدم المرأة ترابط مع المشاعر السلبية تجاه التغيرات الحاصلة، وأصبح بالتالي سبباً للنتائج السيئة وللتغيير، كما أن هذا النمط من التفكير لم يكن محصوراً بالرجال فقط. المرأة بدورها، بعد أن عانت من الضغوطات والخيبات، وبعد أن أُلقيت اللائمة عليها بما حصل، قررت أن الثمن الواجب دفعه باهظ للغاية. لذلك، تقهقرت النساء جماعياً إلى منازلهن، وابتكرن اقتصاد المنزل» و «العلوم المنزلية»، وقمن بتذهيب أقفاصهن بحماس تحت قصف بروباغاندا «المنزل المثالي»، وصوت دوريس داى الذى يتغنى بمتعة (اللمسة الأنثوية … وبقيت الحال هكذا، إلى أن فاق امتعاضهن قدرتهن على التحمل.
مما سبق يتضح لنا أن نضال المرأة اتخذ مساراً تكراريّاً، واستغرق إيصال مطالبها الشرعية إلى مسامع العالم زمناً طويلاً، كما دفعت الكثيرات ثمناً باهظاً عندما رفعن أصواتهن. كتبت عن تاريخ العالم كما ترويه النساء بأنه يمثل ملايين وملايين الأصوات المخنوقة، وهذا صحيح حتى في يومنا هذا، ممّا يضيف حزناً مريراً إلى حقيقة أن العديد منها خَنِقَت على الفور. على سبيل المثال، الكاتبة الأوروغوانية ديلميرا أغوستيني التي نشرت ثلاث مجموعات شعرية ذاع صيتها في كل العالم الناطق بالإسبانية، لقيت حتفها على يد طليقها عندما كانت في الرابعة والعشرين من عمرها.
هناك الكثير من الحالات المشابهة، ومن المسلم به أن نساء كثيرات يعشن في فقر مدقع ويمتن موتاً شنيعاً، لا لسبب إلا لأنهن ولدن إناثاً، رغم ذلك، معظم النساء لسن ضحايا ميلادهن، ولم تحبطهن المعارضة التي واجهنها. التاريخ حافل بنساء ناضلن ضد العراقيل في خضم الكوارث، وقاتلن في سبيل الحياة بحد ذاتها. ماضينا حافل بقصص لا تنتهي عن ملكات الحرب الأمازونيات والآشوريات الإلهة الأم، أنثى الفيل العظيمة، خليلات الأباطرة اللواتي وصلن إلى العرش وحكمن العالم، العالمات السايكوباتيات القديسات والخاطئات ثيوديسيا، هيباتيا، و و تشاو ، فكتوريا كلافلين وودهول و هند آل هند. بالإضافة لهنّ ، هناك ملايين وملايين النساء ممن ينهضن يومياً لإيقاد النار، وتسخين الطعام، وإطعام البشر والحيوانات والاعتناء بالمحاصيل. في المنزل، يقمن بتنظيف المباول وغسل الشراشف الوسخة، ويتوَلَّيْن العناية بالمحتضرين وبالمواليد الجدد. خارج المنزل، ينهضن بمهمة البيع والشراء، وكنس درجات المعبد. معظمهن مجهولات وسيبقين كذلك إلى الأبد، لكن بقاء الجنس البشري يثبت لنا أن كل حياة من تلك الحيوات الخفية هي بشكل ما أو بآخر، انتصار غير معلن. نجاح نساء العالم يندرج ضمن سياق هذه الحقائق البسيطة، لكن الهائلة، وفي عصرنا هذا تحديداً، أثبتت قوى النساء الطبيعية أنها أعظم من أن يتم تهميشها، حتى إن البعض منهن يتمتعن بحرية أكبر فقط لأنهن نساء! لو كنت رجلاً» تقول الطيارة البريطانية أمي جونسون التي حطمت الأرقام القياسية في الطيران لربما انطلقت لاستكشاف القطبين أو تسلقت جبل إيفرست، لكن روحي وجدت حريتها في الريح. الآن، تمتلك النساء في كل مكان الفرصة للتمتع بحرية تفوق حرية الماضي، حتى أشدّ الأنظمة قمعاً لم يعد بإمكانها إخفاء ما تقوم به عن الرأي العام العالمي، أو عن شبكة الإنترنت.
الحرية الحقيقية لبنات جنسنا لا تعني فقط حرية العمل أو السفر أو الدفاع عن النفس، بل أيضاً حرية اختلاف كل امرأة عن الأخرى بصفات مهمة. يمكننا معرفة التقدم الذي تحقق بقياس الشوط الذي قطعناه منذ تعالت صرخة فرويد: «ماذا تريد النساء ؟». نَضْجُنا يهبنا القوة كي ندرك أنه لا وجود لأجندة موحدة، ولا لأي برنامج إصلاح اجتماعي يلبي احتياجات أو مطالب النساء جميعهن. مثلما يتقبل الرجال أن مصالح الجماعات المختلفة ستتصادم حتماً، أدركنا نحن النساء الآن أن التوافق بالرأي حول كل شيء ليس ضرورياً، وأدركنا أننا نختلف بعضنا عن بعض اختلافاً جذرياً من حيث الدين، العرق، البلد الميول الجنسية، والطبقة الاجتماعية. يركز نضالنا اليوم على تحقيق حرية كل امرأة سواء كانت ميولها الجنسية غيرية أو مثلية سواء كانت متزوجة أو عازبة، لديها أولاد أم لا، فقيرة، غنية، قصيرة، طويلة سمينة، نحيلة… إلخ – بممارسة خياراتها كإنسان، واعتبار هذه الممارسة حقاً من حقوقها. حريتنا عديمة المعنى ما لم توسعها لتشمل جميع سكان الكوكب، الإنسانية الكاملة» يجب أن تأخذ بحسبانها الرجال أيضاً، وإلا فلن تحصل عليها النساء. في لحظة ما خلال الأعوام الثلاثين الماضية، رأت النساء بعضهن بعضاً بعيون جديدة، وتنهدن إزاء كل العمل الواجب إنجازه:لقد فهمن أن ما يقمن به لإنقاذ عالمهن يجب أن يشمل الرجال، والأطفال كذلك. فقط عندما ندرك أن بإمكان الرجال والنساء أن يتحدوا ضد كل ما يعيقنا نحن عندها نستطيع أن ندافع عن صحتنا وسعادتنا المشتركة. هذه هي المهمة التي تنتظرنا، ولن نقبل بالفشل.
من الصعب هدم معاقل التمييز الصريح ضد النساء، لكن هدم التعصب المعشش فى اللاوعى أصعب. لهذا السبب، وبناء على كل ما سبق، الحاجة إلى تاريخ النساء لم تتضاءل خلال السنوات التي تلت صدور الطبعة الأولى، بل على العكس. في الحقيقة، نحن ما زلنا فى البدايات فقط مئات آلاف القصص المدهشة تنتظر التنقيب عنها بين رمال الزمن، قصص عن الحاكمات في عصر الملكات الأوروبي، عن المزارعات القويات وصانعات البيرة عن التاجرات وحكيمات القرى اللواتي يحافظن على تماسك مجتمعاتهن في كل مكان من العالم، ومن خلال ذلك يحفظن الجنس البشرى حيّاً. إخراج تلك القصص إلى الضوء ضرورى من أجل استعادة مكانة النساء في العالم – سواء مكانتنا نحن، أم مكانة بناتنا وحفيداتنا كما أن الحاجة إليها ستتزايد أكثر فأكثر، ونحن نشق طريقنا عبر الألفية الجديدة عازمات على تحقيق ما نصبو إليه. تلك القصص البديعة عما قامت به المرأة خلال خمسة آلاف عام، ستلهمنا بناء عالم جديد أفضل، وستشكل قاعدة نستند إليها، لأنها مصدر لا ينضب يساعدنا على تمرين عضلات شجاعتنا. الأهم من كل ما سبق، هو أنها ستذكّرنا كم أن النساء رائعات، وكم قطعنا في سبيل تحقيق أهدافنا.
عندما شارفت السنة الحادية عشرة المصيرية، من فترة تولي مارغريت ثاتشر لمنصبها على الانتهاء، يُقال إن صبياً بريطانياً صغيراً سأل: هل يمكن أن يصبح الرجل رئيس وزراء ؟!»، تماماً مثلما كان أي طفل سيطرح السؤال ذاته في زمن الملكات الفرعونيات في مصر، أو في حقبة كاترين الكبرى في روسيا. الفرق هو أن ثاتشر وغيرها من رئيسات الوزراء لسن شذوذاً نادراً في عالمنا اليوم، بل يمثلن الشعب، ويُنتخبن لا مرّة واحدة، بل مرات عديدة المرأة اليوم لا تستلم منصبها بسبب عدم وجود رجال مناسبين، نحن هناكي نأخذ موقعنا جنباً إلى جنب مع الرجل، ونواجه الحياة معاً.
إذن، تستحق المرأة تاريخاً خاصاً بها وحدها، إن كنا سنصغي إلى قصتها الحقيقية. في الواقع، إنها قصص كثيرة، لا قصة واحدة سيسعدني أن أرى النساء في كل مكان، وهنّ يكتبن قصصهن وقصص أمهاتهن وجدانهن وأن ينقب المؤرخون الذكور بدورهم في ذلك المنجم الخصب. تلزمنا كتب عديدة تتناول تاريخ النساء، وهدفي كان أن أنصف مخاوف النساء جميعهن في عصرنا الحالي، وكذلك مخاوف الرجال، لأنها تؤثر على المرأة في كل العالم. من طبخت العشاء الأخير؟» لا يدعي أنه يقبل بخرافة النزاهة التاريخية» التقليدية، النساء من الغالبية العظمى المظلومة في تاريخ العالم، ومعاناة هذه الغالبية ما تزال مستمرة، ولن نفي هذه الواقعة حقها مهما صرخنا ومهما تكلمنا. سيقول بعض الرجال إنّ هذا ليس عدلاً، وستتعالى حسرتهم شيئاً فشيئاً في مجتمع يحاول إنصاف الطرف الآخر، كما سيدعي آخرون أن المرأة ثملت بالسلطة وأصبحت غير منضبطة بعد انتصارها في معركة الجندر، وأنّ الرجل هو الضحية اليوم. «مسألة الرجل» خطفت الأضواء من مسألة المرأة الراسخة التي شغلت القرن التاسع عشر، بعد أن أذهلتنا النتائج المدرسية التي كشفت أنّ الفتيات يتفوقن على الصبية، وأن الرياضيات الإناث يركضن أسرع من أولئك الرياضيين الذكور الذين فازوا بالميداليات الذهبية في الألعاب الأولمبية الأولى، وأن بطل التنس بوبي ريغز خسر أمام بيلي جين كينغ الصغيرة. كل مكسب، وكل نجاح تحققه المرأة، يُفسر على أن الرجال يُخدعون ويُهانون من وجهة نظري، من الأفضل أن نعكس السؤال: عندما كانت المرأة تكدح بكل عضلة، وكل عصب، وكل خلية في جسدها، طيلة العقود الثلاثة الأخيرة كي تعيد تشكيل ذاتها وحياتها وتشكيل العالم، ماذا فعل رجل القرن العشرين خلال ذلك الوقت؟! وكم سيطول به الأمر حتى ينضم إلينا ويدعمنا ؟!
رسالتنا بسيطة وواضحة للغاية، ولا يُمكن إنكارها. كل الثورات في تاريخ العالم، وكل الحركات من أجل المساواة، عجزت عن تحقيق المساواة بين الجنسين، بعد آلاف السنين، وفي حقبتنا هذه، بدأنا بتغيير ذلك الواقع…. دعونا لا نتوقف قبل أن نتحرّر جميعنا.
إحالات:
- حصلت المرأة الكويتية على حق الاقتراع عام 2005، أي بعد أربعة أعوام من صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب المترجمة
- Rosie the Riveter كانت نجمة حملة استهدفت تجنيد النساء للعمل في الصناعات الدفاعية خلال الحرب العالمية الثانية، وأصبحت أشهر أيقونة تجسد المرأة الأمريكية. المترجمة
اقرأ أيضا